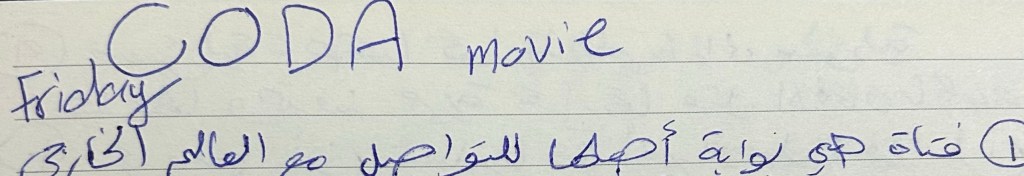قديمًا، منذ سنوات طويلة شاهدت فيلمًا وكان هناك شيخ كبير له صديق صغير، يعلمه الحياة ويتعلم منه ربما معنى الحياة! حين شاهدته أعجبتني الفكرة وتمنيت لو أن هناك طفلة صغيرة أجرب معها نفس هذا الدور وهو غريب لحد ما، إذ لا قرابة واضحة تستدعي التقاء ذلك الشيخ بالطفل. ثم شاء الله سبحانه وصارت لي رفيقة درب من وإلى المدرسة، نلتقي صباحًا وفي الظهيرة، نتبادل التحايا والأحاديث وهواجيس الطريق، طفلة ذكية في صفها الأول الابتدائي. حتى مع قصر المسافة الزمنية المقضية بيننا، إلا أن اختلاق الأحاديث والضحكات وشمس الظهيرة تجمعنا، وبيننا بضع وعود صغيرة.
أذهب أنا إلى قسم الثانوي، أنظر إليها وهي في طريقها إلى قسم الابتدائي وبالتحديد الصفوف الأولية. وقد تدرجنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، استغرقنا فصلًا دراسيًا كاملًا! معها غيرت بوابة دخولي إلى المدرسة لتكون الأقرب إلى قسمها والأبعد عن قسمي، غيرت بوابة الدخول بعد سنوات من ثباتها لأجد سيارتي في الظهيرة قبالة الشمس فتتحول إلى كهف ساخن حين خروجنا، لم يقتصر الأمر على ذلك، كنت أوصلها بنفسي إلى بوابة قسمها وفي الظهيرة ولفارق ربع ساعة تسبقني بانتهاء دوامها أذهب وآخذها إلى مكتبي حتى وقت خروجي. ثم انتقلنا إلى معرفة أقسام المدرسة، هنا وهناك انظري إلى حرف الثاء؟ هذا يعني ثانوي وهنا ب؟ ابتدائي، أنت من هنا وأنا من هناك، ثم تطور الأمر وكونت صديقتي (الطفلة😂) صداقات مع كل من في غرفتي معلمات المتوسط والثانوي! وصارت تعلم بالضبط متى تغادر قسمها مزهوة إلى مكتبي، تستقبلها التحايا يوميًا، لم يقف الأمر إلى هنا، تعرف أيضًا أماكن تواجدي إن لم أكن في الغرفة. وذات يوم تفاجأت بها دعت صديقتها لترى أبلة مشاعل وهي جالسة في مكتبها 🤓 أين المشكلة؟ أهل صديقتها ينتظرونها بالخارج بينما هنا يدار تعارف جديد هههههه. بالمناسبة، بدأنا في تعلم بوابات المدرسة وهي ثلاث، وصعبة على طفلة لكن أتيتها بحيلة، غيرت مكان توقفي -مرة أخرى-، ثم أسألها ظهرًا، وين وقفنا اليوم؟ من هنا علمتها ثم صرت أسألها فتأخذ ثوان للتذكر. طفلة في صفها الأول تتعلم شرقية وغربية وشمالية ثم هي نفسها كل بوابة تحمل اسمين، جهة ورقم فتستدرك: بوابة ١! نعم ما زلنا عند تعلم البوابة الأولى.
تعلمت مني: have a nice day! لأني أقولها يوميًا وهي تغادر إلى قسمها وفي يوم وهي نازلة إلى منزلها قالتها بسرعة.. ثم نظرت إلي قائلة: قلتها قبلك ☺️
لاحظنا من طول انتظارنا إشارة معطوبة متدلية ونسجنا خيالات، قالت لي: يمكن تطيح فوق سيارتنا؟ / لا احنا ما نمشي من تحتها شوفي احنا نروح يسار/ اممم صح كلامك، راقبناها إلى أن أصلحوها فسألتها: طالعي ايش اللي تغير؟ هاه لاحظي كويس! صرخت: صللللحو الإشارة. في ذات الإشارة نراقب السحاب عندما يكون الطقس غائمًا، أطلب منها: شوفي السحاب تمشي / كيف عرفتي؟ / طيب انا اقولك طالعي في طرف عمود النور وشوفيها من ورا وهي تمشي او طالعي طرف المبنى هذاك وشوفيها.. وبعد ثواني من التأمل: والله صح تمشي!
عرفتُ قوائم تشغيلها المفضلة، وخططها لنهاية الأسبوع، وخمولها يوم الأحد، وتميزها وأدبها، سألتني: ايش تسجعي؟ الهلال ولا الاتحاد؟ طلبت منها إعادة السؤال للتأكد من تسجعي؟… أجبتها: صراحة ما أسجع ولا فريق!
أطلعتني على مكان جلوسها في الفصل، ومن هم صديقاتها، ورقمها التسلسلي، صارت تعرف كما قلت متى تغادر قسمها وطريق وصولها إليّ، وأي الكراسي تحركه لتجلس إما بجواري أو أمام مكتبي. أسألها كل يوم: كيف كان يومك؟ وصارت تعرف كيف تجيب، تصف لي يومها منذ أن تركتها للحظتنا، وهي تحسب الفسحة (حصة الفسحة) وعندما لا تكون في مزاج جيد تختصر الإجابة، فـ أُطيلها بسؤال: من من صديقاتك سعادتك اليوم؟ / ساعدتني في ايش؟ / اممم في حل أوراق العمل؟/ احنا كل وحدة لها ورقة لوحدها -_-
هناك أيام وهي قليلة يكون الصمت سيد الموقف، صباحًا أو في العودة، إما لنعاس يكاد يأكلنا أو لمزاج مرهق! لكن وجودها غير من روتين صباحي، وصرت أصل مبكرة لا لبصمتي وإنما لوقت الحصة الأولى، لا أريد أن تفوتها أي فقرة صباحية إن وجدت.
أحب الأطفال، ومن يعرفني يعلم ذلك، أحب قضاء وقت معهم وإن قصر، ومحادثتهم ومشاركتهم وتعليمهم وكل ما اتصل بهم، هي سارة وسارّة فعلًا، كثيرًا ما ابتسم أو أضحك بسببها، سعيدة بها.
ملاحظة:
أثناء كتابتي قفز إلى رأسي الكثير من الحوارات التي كانت بيننا، لكن آثرت الاحتفاظ بها، أفكر في كتابتها بدفتر يومياتي، لكونها عفوية لحظية ولطيفة.